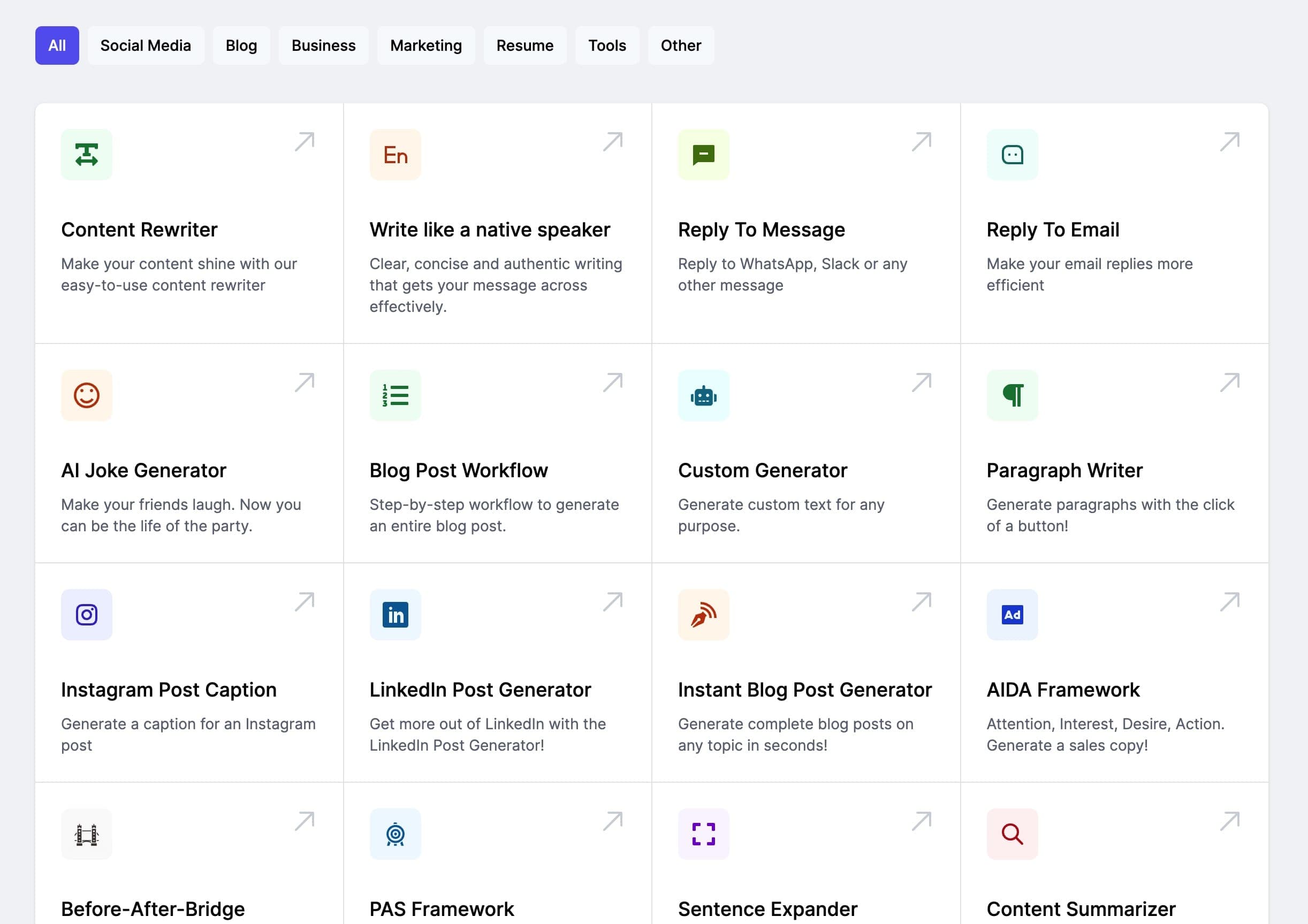دروس وعبر وفوائد من السيرة النبوية (1)
لا شك في أن دروس السيرة النبوية أعظم دروس؛ وذلك لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم سيرة عرفتها البشرية، أتدرون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محلًّا للرعاية والعناية الإلهية المذكورة في قوله عن موسى: ﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ [طه: 41]، وقوله: ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ [طه: 39].
وتظهر هذه العناية في الحديث عن نسبه، وزواج أبيه وأُمِّه، وموت أبيه وهو حمل في بطن أُمِّه لشهرين، وولادته، وما رأته أُمُّه من الآيات في حمله وولادته، واسترضاعه في بني سعد، وشقِّ صدره الشريف، وله أربع سنوات، وودِّه لأُمِّه، وموت أُمِّه وكفالة جده عبد المطلب له، وموت جده وكفالة عمه أبي طالب له، وزواجه بخديجة... إلخ.
كل هذا جرى بشيء من العناية الإلهية لتهيئة النبي صلى الله عليه وسلم وإعداده النفسي والروحي لاستقبال الرسالة.
إن الحديث عن السيرة النبوية يأتي من باب قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: 21][1]، وهذه الآية تُبيِّن أن الأسوة الحسنة إنما يبحث عنها ويختص بها المؤمن بالله واليوم الآخر إيمانًا حقيقيًّا، وهذا له سبب وله عِلَّة قوية جدًّا، وهو يشبه قوله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى ﴾ [الممتحنة: 4]... إلى أن قال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ [الممتحنة: 6]، فانظر كيف ربط سبحانه وتعالى بين متتبع ومقتفي الأسوة الحسنة وبين الإيمان بالله واليوم الآخر.
والإنسان مجبول على التأسي في مختلف مراحل حياته؛ بدءًا من الطفولة، إذ يقوم الطفل الصغير بالاقتداء بالكبار باعتبارهم مثله الأعلى، ويبدأ باكتساب العادات والتقاليد والملكات من خلال ما يسمعه ويلاحظه من أقوال وحركات وانفعالات، والتلميذ يتدرَّب على الصنعة بالتأسي بالأستاذ والمعلم.
ويرجع البعض السر في نجاح اليابانيين والصينيين إلى أنهم أكبر المقلدين في العالم، فالسِّرُّ الذي يكمن وراء النجاح الباهر لاقتصادهم ليس هو الاختراعات الفريدة، بل إنهم يبدؤون من العمل بأخذ المنتجات والأفكار من شتى الجهات وعلى نطاق واسع، ويحافظون على العناصر المهمة في تلك الأفكار والمنتجات ويطوِّرون الجوانب الأخرى.
ونحن في علاقاتنا مع أولادنا وأبوينا وأزواجنا، وفي مأكلنا ومشربنا وعباداتنا ودعواتنا وسائر أعمالنا إذا رأينا أننا أحرار ونستطيع أن نتصرف كما نشاء تكون هذه دعوة للعلمانية والانسلاخ من الوحي والشريعة السماوية والتخلي عن الأسوة الحسنة والقرآن والسنة من كل وجه[2]، ولكن علينا ألا ننسى أن الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم لم يتركه سُدًى، ولم يدَعْه بدون أسوة، سائبًا يسرح ويمرح في الحياة من دون هادٍ أمين، بل هداه بالقرآن إلى الأسوة الحسنة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: 21] و﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران: 31].
وفي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته يجد المرء الأسوة الحسنة في حياته كلها؛ فهو إنسان أكرمه الله سبحانه وتعالى برسالته، وسيرته شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان، فهو الشاب الأمين قبل البعثة، والتاجر الصدوق، وهو الباذل لكل طاقته في تبليغ دعوة ربِّه، وهو الأب الرحيم، والزوج المحبوب، والقائد المحنك، والصديق المخلص، والمربي المرشد، والحاكم العادل، كما أنه صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى في تربية الذات من جميع النواحي؛ سواء في عبادته، أو زهده، أو خلقه الكريم، أو غير ذلك، فالذين أحبوه واتَّبعوا مبادئه، واقتدوا به واتخذوه أسوة في ذلك العصر، بنوا حضارة إنسانية كبيرة وعظيمة بقيت آثارها حتى اليوم، ومن بعد ذلك قامت الدول الإسلامية الكبيرة على خُطى النظام الذي جاء به مثل الدولة الأموية والعباسية والسلجوقية والنورية والصلاحية والمملوكية وأخيرًا العثمانية، وكم نشأ وترعرع في ظل تلك الدول علماء دعاة اهتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم، وسبقوا عصورهم، وألقوا بضيائهم إلى أيامنا هذه، فها هم سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبقية العشرة، ثم الكثير والكثير من المهاجرين والأنصار، ثم التابعون وتابعوهم وهكذا.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
دروس وعبر وفوائد من السيرة النبوية (2)
المولد النبوي
لما وُلِدَ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمًا، وعبدالمطلب جد النبي هو الذي سمَّاه بهذا الاسم، ولم يكن شائعًا عندهم، ولما سُئل عن اختيار هذا الاسم قال: "حتى يحمَده أهل السماء والأرض".
قال ابن كثير: "ألهمهم الله تعالى أن يُسمُّوه محمدًا؛ لِما فيه من الصفات الحميدة؛ كما قال حسان بن ثابت:
وَضم الإلَه اسم النَّبِي إِلَى اسْمه
إِذا قَالَ فِي الْخمس الْمُؤَذِّنُ: أشْهَدُ
وشقَّ له من اسمه لِيُجِلَّه
فذو العرشِ محمودٌ وهذا محمدُ
وقيل: كان عبدالمطلب وثلاثة من العرب في رحلة إلى الشام، وكانوا أهلَ كتابٍ يعرفون أنه سيخرج نبيٌّ في جزيرة العرب واسمه محمد، فعزم كل واحد منهم على تسمية ابنه بمحمد، والله أعلم.
ومُحَمَّدٌ اسم مفعول على وزن (مُفَعَّل) مشتق من (حُمِّد) يفيد المبالغة في الحمد، وارتباطه بالحمد، فهو أحمَدُ الناس لربِّه، وهو أكثر الناس حمدًا لربه، ويفتح الله عليه بمحامدَ لم يفتحها على أحد قبله، وبيده لواء الحمد، وافتتح الكتاب الذي جاء به بالحمد، وسورة الحمد أعظم سورة، وهو صاحب المقام المحمود، وأمَّتُه الحمَّادون يحمَدون الله على السراء والضراء، ويحمدون الله على كل حال.
وجاء في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف: 6]، ولم يقل (محمد).
وهنا لفتة بلاغية إعجازية في القرآن؛ لأن (أحمدَ) غير (محمدٍ) في المعنى، فـ(أحمدُ) يعني هو أحمد الناس لله، يعني هو الذي سيقوم بالحمد، و(محمدٌ) اسم مفعول يعني أنه يُحمد على خصاله الجميلة وأخلاقه العظيمة، فاسم المفعول يقتضي فاعلًا وفعلًا ومفعولًا، وهو لم يأتِ بعدُ، ولم يُخلَق، ولم يُرسَل، فناسب، فوصفه بأحمدَ دون محمدٍ، فهو قبل بعثته أحمدُ وبعدها محمدُ.
وفي هذه الأيام يتهيأ بعض المسلمين للاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي، وقبل كل شيء ينبغي أن نفهم أن يوم المولد لم يكن معروفًا ومحددًا في تاريخ المسلمين، وإنما يقولون في عام الفيل ما بين سنة 570 - 571 م، واختلفوا بعد ذلك اختلافًا كثيرًا.
وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه وُلِدَ يوم الاثنين؛ فكان يصوم هذا اليوم شكرًا لله تعالى، فالمقطوع به أنه يوم الاثنين، والمختلَف فيه أنه في أي شهر، وأي يوم في هذا الشهر.
تعظيم يوم الميلاد والاحتفال به، وجعله عيدًا موسميًّا يحتفل به ويدخل في ثقافة الإنسان، هذا ليس من سنن المسلمين، بل لم نَرَ في تراث الإسلام ولا تاريخ المسلمين تعظيمَ الأيام التاريخية؛ مثل: يوم نزول القرآن، ويوم الهجرة، ويوم بدر، وفتح مكة، وغير ذلك.
وتُنسَب بداية الاحتفال بالمولد النبوي للخليفة المعز لدين الله الفاطمي على سبيل القرب للمصريين الرافضين لحكم الدولة الفاطمية الشيعية، وذلك في القرن الرابع الهجري، وقد منعه الأيوبيون (دولة صلاح الدين الأيوبي)، وسمح به المماليك، حتى تحوَّل إلى عيد رسميٍّ صوفيٍّ في عهد محمد علي باشا.
ولا شكَّ أننا لو سألنا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عن سبب الاحتفال بيوم المولد، لكان جوابهم بالإجماع أنه بسبب حبهم لرسول الله، فالدافع هو الحب، حينئذٍ ينبغي أن نقول: الحبُّ الحقيقيُّ للنبي صلى الله عليه وسلم في التأسِّي به، ومتابعته، بل حبه صلى الله عليه وسلم فرع عن محبة الله المقرونة باتباعه؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾ [آل عمران: 31].
ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المظهر العمليُّ لشريعة الله تعالى؛ فهو المكلَّف الأول: ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 163]، ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: 143]، وهو القدوة الصالحة: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21]، وهو الذي يتلقى الوحي من السماء: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4]، وهو الذي أدَّبه ربُّه، فأحسن تأديبه، وهو الذي قذف الله النور في قلبه، وأجرى الحق على لسانه، وجعل طاعته من طاعته، ومعصيته معصية له سبحانه: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء: 80].
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة وليس القدوة؛ لأنه أسوتنا في كل شيء، ولذلك زكَّاه الله في عقله وسمعه، وبصره وكلامه وخُلُقه، وشرح صدره، وجعل غِناه في قلبه؛ فهو أسوة في كل قول وفعل، وأما القدوة فتكون في بعض الأمور فقط؛ يعني في أمر مخصوص.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في سفر وناموا، فما أيقظهم إلا حرُّ الشمس؛ قال أبو قتادة الأنصاري: فجعل بعضنا يهمِسُ إلى بعضٍ: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: ((أمَا لكم فيَّ أسوة؟ ثم قال: أمَا إنه ليس في النوم تفريطٌ، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاةَ، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى))، وكان الصحابي إذا رأى رجلًا يفعل شيئًا مخالفًا للسُّنَّة يقول للفاعل: أمَا لك في رسول الله أسوة؟
وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول: "أفْعَلُ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد قال الله: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21]".
قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ﴾ [الأنعام: 83، 84] إلى أن قال: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾ [الأنعام: 90].
وفي هذه الآيات فائدتان:
الأولى: أنه رَبَطَ بين الاقتداء والهدى الذي هو من عند الله، فالقدوة بدون هداية من الله لا تكون على منهاج النبوة، كمن يتخذ له قدوة في اللعب والكرة، والفن والرقص، وغير ذلك، فهذه قدوة بغير هُدًى من الله، وقد جَعَلَ الله مِنَ الناس مَن هو قدوة في الخير، ومن هو قدوة للناس في الشر، ومنه حديث: ((من سنَّ سُنَّة حسنة...)).
الثانية: أنه تعالى أمر نبيَّه أن يقتدي بهم فيما هداهم الله به؛ وهو الوحي والعلم، ولم يأمره بالاقتداء بهم اقتداء مطلقًا؛ لأنه أفضل وأعلى قدرًا منهم، وهو خيرهم وإمامهم وسابقهم إلى الجنة.
ولأن طبيعة الناس في الحياة الدنيا تفتقر إلى القدوة؛ لأنها من الرياسة أو القيادة أو الزعامة.
لا يصلح الناس فوضى لا سَراة لهم
ولا سَراة إذا جُهَّالُهم سادوا
والفوضى هي اختلاط الأمور بعضها ببعض، والسَّراة: السادة، ولا سادةَ إذا ساد الجهَّال، والنزوع إلى اتباع قائد معين ليس مما فطر الله عليه بني الإنسان فحسب، بل يشاركهم في ذلك بعض الحيوانات وحتى الحشرات.
وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه، وسلم.
دروس وعبر وفوائد من السيرة النبوية (3)
عام الفيل، الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بهذا الاسم للقصة المشهورة في سورة الفيل: ﴿ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل * ألم يجعل كيدهم في تضليل * وأرسل عليهم طيرا أبابيل * ترميهم بحجارة من سجيل * فجعلهم كعصف مأكول ﴾ [الفيل: 1 - 5].
هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش، فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل، الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله، وأرغم آنافهم، وخيب سعيهم، وأضل عملهم، وردهم بشر خيبة، وكانوا قوما نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال.
1- وأصل ذلك أن ملك حمير المشرك الوثني الذي قتل المؤمنين من النصارى في اليمن في قصة أصحاب الأخدود، هرب بعضهم إلى الشام، واستنجد بقيصر الروم، فأرسل إلى النجاشي ملك الحبشة في غزو اليمن، وقتل ملك حمير الوثني، فأرسل النجاشي أميرين أرياط وأبرهة، ثم استقر حكم اليمن لأبرهة، وبنى كنيسة عظيمة تسمى القليس؛ لإرضاء ملك الحبشة، وأراد صرف حج الناس إليها بدلا من مكة، فنادى بذلك في اليمن، فكرهت العرب ذلك، وعلمت قريش به، فغضبوا، وذهب بعض العرب فدخل الكنيسة ليلا، فأحدث فيها وخربها، فلما أصبحوا وعلم أبرهة، أقسم ليسيرن إلى مكة وليهدمن الكعبة حجرا حجرا، فتجمع رجال من العرب، وهاجموا جيش أبرهة، لكنه انتصر عليهم، وأسر بعضهم، وقصد مكة في جيش كبير ومعهم عدة أفيال، وفيها فيل عظيم يقال له: محمود، فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله - وكان اسمه محمودا - وعبأ جيشه، فلما وجهوا الفيل نحو مكة، أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه، ثم أخذ بأذنه وقال: ابرك محمود، أو ارجع راشدا من حيث جئت؛ فإنك في بلد الله الحرام، ثم أرسل أذنه، فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين، وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم، فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن، فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك، وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره، وحجران في رجليه، أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق؛ قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق، ويهلكون على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون، وأنزل الله على رسوله بعد ذلك: ﴿ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل * ألم يجعل كيدهم في تضليل * وأرسل عليهم طيرا أبابيل * ترميهم بحجارة من سجيل * فجعلهم كعصف مأكول ﴾ [الفيل: 1 - 5]، وقال بعدها: ﴿ لإيلاف قريش * إيلافهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا رب هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ﴾ [قريش: 1 - 4].
الأبابيل: الكثيرة المتتابعة المجتمعة، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش، بركت ناقته، فزجروها فألحت، فقالوا: خلأت القصواء؛ أي: حرنت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله، إلا أجبتهم إليها، ثم زجرها فقامت))؛ [رواه البخاري]، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: ((إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب)).
هدم الكعبة وبناؤها:
2- بناء قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام، وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة، قامت قريش في بناء الكعبة حين تضعضعت، واتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها إلا طيبا، فلا يدخلوا فيها مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهابون هدمها، فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي، وتبعه الناس لما رأوا أنه لم يصبه شيء، ولم يزالوا في الهدم، وأخذوا يبنونها، ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود، اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع أربع ليال أو خمسا، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم، إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد، فارتضوه، وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين، رضيناه، هذا محمد، فلما انتهى إليهم، وأخبروه الخبر طلب رداء، فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه، حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده، فوضعه في مكانه، وهذا حل حصيف رضي به القوم، وقصرت بقريش النفقة الطيبة، فأخرجوا من الجهة الشمالية نحوا من ستة أذرع، وهي التي تسمى بالحجر.
3- وبناء عبدالله بن الزبير بإدخال الحجر وذلك لما ولي بلاد الحجاز، وقد زالت العلة التي من أجلها تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ففي البخاري من طريق يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين؛ بابا شرقيا، وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم))، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه، قال يزيد: "وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه، وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم، حجارة كأسنمة الإبل".
4- وبناء الحجاج بن يوسف الثقفي[1] بإخراج الحجر وهو الموجود حتى الآن.
وفي عهد عبدالملك بن مروان كتب الحجاج بن يوسف الثقفي إليه فيما صنعه ابن الزبير في الكعبة، وما أحدثه في البناء من زيادة، وظن أنه فعل ذلك بالرأي والاجتهاد، فرد عليه عبدالملك بأن يعيدها كما كانت عليه من قبل، فقام الحجاج بهدم الحائط الشمالي، وأخرج الحجر كما بنته قريش، وجعل للكعبة بابا واحدا فقط، ورفعه عاليا، وسد الباب الآخر، ثم لما بلغ عبدالملك بن مروان حديث عائشة رضي الله عنها، ندم على ما فعل، وقال: "وددنا أنا تركناه وما تولى من ذلك"، وأراد عبدالملك أن يعيدها على ما بناه ابن الزبير، فاستشار الإمام مالك في ذلك، فنهاه خشية أن تذهب هيبة البيت، ويأتي كل ملك وينقض فعل من سبقه، ويستبيح حرمة البيت.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أهل الشام وأمراءهم، يزيدا أو الحجاج أو حصين بن نمير، لم يكونوا يقصدون الكعبة، وإنما مقصدهم محاربة أهل مكة؛ قال الدكتور الصلابي في كتاب الدولة الأموية: "لا شك أن أحدا من أهل الشام لم يقصد إهانة الكعبة، بل كل المسلمين معظمون لها، وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير، والضرب بالمنجنيق كان لابن الزبير لا للكعبة، ويزيد لم يهدم الكعبة، ولم يقصد إحراقها، لا هو ولا نوابه باتفاق المسلمين"؛ ا.هـ.
(والقرامطة)[2] وهم من الملاحدة في سنة 317 ه دخلوا المسجد الحرام، فسفكوا دم الحجيج في وسط المسجد حول الكعبة، وكسروا الحجر الأسود، واقتلعوه من موضعه، وذهبوا به إلى بلادهم، ثم لم يزل عندهم إلى سنة 339، فمكث غائبا عن موضعه من البيت 22 سنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
5- وأما آخر بناء للكعبة فكان في العصر العثماني سنة 1040 للهجرة، عندما اجتاحت مكة سيول عارمة أغرقت المسجد الحرام، حتى وصل ارتفاعها إلى القناديل المعلقة؛ مما سبب ضعف بناء الكعبة، عندها أمر محمد علي باشا - والي مصر - مهندسين مهرة، وعمالا يهدمون الكعبة، ويعيدون بناءها، واستمر البناء نصف سنة كاملة، وكلفهم ذلك أموالا باهظة، حتى تم العمل.
دروس وعبر وفوائد من السيرة النبوية (4)
أهم وأشهر الأحداث قبل البَعثة:
1- حادثة شَقِّ الصدر: وقعت له وهو طفل، وعند البعثة، وكذلك عند الإسراء والمعراج[1]:
حصل له ذلك وهو في بني سعد[2] في السنة الثالثة من عمره، وقيل: في الرابعة؛ وذلك لتطهيره وإخراج حظ الشيطان[3]، فأحْدَثَ ذلك عند حليمة خوفًا فردَّتْه إلى أمه، ثم إن أمَّه أخذته منها، وتوجَّهت به إلى المدينة؛ لزيارة أخوال أبيه بني عَديِّ بن النجار، وبينما هي عائدة أدركتها مَنِيَّتُها في الطريق، فماتت بالأبواء، فحضنتُه أم أيمن، وكفله جَدُّه عبدالمطلب، ورقَّ له رِقَّةً لم تُعهَد له في ولده؛ لِما كان يظهر عليه مما يدل على أن له شأنًا عظيمًا في المستقبل، وكان يكرمه غاية الإكرام، ولكن لم يلبث عبدالمطلب أن تُوفِّيَ بعد ثماني سنوات من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكفله شقيق أبيه أبو طالب، فكان له رحيمًا، وعليه غَيورًا، ولا يطمئن بعض الجاهلين - ومعهم المستشرقون - إلى قصة «شق الصدر» واستخراجه، ومعالجته، سواء التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند حليمة السعدية، أو ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب في معجزة الإسراء والمعراج، وابنُ حبَّان منذ أكثر من ألف سنة يناقش الموضوع، ويعتبره من معجزات النبوة؛ ويقول: "كان ذلك له فضيلة فُضِّل بها على غيره، وإنه من معجزات النبوة؛ إذ البشر إذا شُقَّ عن موضع القلب منهم، ثم استُخرج قلوبهم، ماتوا".
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام، وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه وصرعه، فشقَّ عن قلبه فاستخرج القلب، واستخرج منه علقه سوداءَ، فقال: هذا حظ الشيطان، ثم غسله في طَسْتٍ من ذهب بماء زمزم، ثم لَأَمَهُ، ثم أعاده في مكانه[4]، وجاء الغلمان يسعَون إلى أمه - يعني ظِئرَه - فقالوا: إن محمدًا قد قُتل، فاستقبلوه، وهو مُمْتَقِعُ اللون، قال أنس: وقد كنت أرى ذلك الخيط في صدره))، وهناك رواية أخرى عن شرح الصدر في الصحيحين، عن أنس بن مالك بن صعصعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فُرج سقف بيتي وأنا بمكةَ، فنزل جبريل، ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطَستٍ من ذهب مملوءٍ حكمةً وإيمانًا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه)).
وهذا يشبه ما صحَّ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم من أحدٍ إلا وقد وُكِّل به قرينه من الجن، وقرينه من الملائكة، قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسْلَمَ، فلا يأمرني إلا بخير))، وفي حديث عن عائشة رضي الله عنها، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أغِرْتِ؟ قالت: وما لمثلي لا يَغارُ على مثلك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكِ شيطانكِ، قالت: أو معي شيطان؟! قال: ليس أحدٌ إلا ومعه شيطان، قالت: ومعك؟ قال: نعم، ولكن أعانني الله عليه فأسلم))؛ أي: انقاد وأذعن، فلا يستطيع أن يهجِس بشرٍّ.
2- رعي الغنم:
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قَرَارِيطَ لأهل مكة))، وفي حديث جابر رضي الله عنه: قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتني الكَبَاثَ، فقال: ((عليكم بالأسود منه؛ فإنه أطيبه، قال: قلنا: وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم، وهل من نبيٍّ إلا قد رعاها)).
3- التجارة مع الصدق والأمانة:
وفي الخامسة والعشرين من عمره المبارك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم تاجرًا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها، وكانت خديجةُ بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها، وتضاربهم إياه، بشيء تجعله لهم، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرًا، وتعطيه أفضلَ ما كانت تعطي غيره من التجار، فقبِله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مالها، وخرج معه غلامها ميسرة، وجعل عمومته يُوصُون به أهل العِير، حتى قدِما بُصرى من الشام، فنزلا في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب من الرهبان يُقال له: "نسطور"، فاطلع الراهب إلى ميسرة، فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم، فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبيٌّ، ثم قال لميسرة: أفي عينيه حُمرة؟ قال: نعم لا تفارقه، فقال: هو نبي وهو آخر الأنبياء، ثم باع النبي صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها، فوقع بينه وبين رجل مُلاحاة، فقال له: احلف باللات والعزى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حلفتُ بهما قط، وإني لأمرُّ فأُعرِض عنهما، فقال الرجل: القول قولك، ثم اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يشتري، وأقبل قافلًا إلى مكة، ومعه ميسرة، وكان الله قد ألقى عليه صلى الله عليه وسلم المحبة من ميسرة، فكان كأنه عبدٌ له، فلما كانوا بمر الظهران، قال ميسرة: يا محمدُ، انطلق إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك، فإنها تعرف ذلك لك، فتقدَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة في ساعة الظهيرة، وخديجة في علية لها، فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعير، ومَلَكَانِ يُظِلَّانه، فأرَتْهُ نساءها فعَجِبْنَ لذلك، ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبَّرها بما ربحوا في وجههم، فسُرَّت بذلك، فلما دخل ميسرة عليها أخبرته بما رأت، فقال: قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام، وأخبرها بما قال الراهب "نسطور"، ثم باعت خديجة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من تجارة، فربِحت ضعفَ ما كانت تربح، وأضْعَفَتْ له ضعف ما كانت تعطي رجلًا من قومه.
4- زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها:
كانت خديجة رضي الله عنها تُسمَّى سيدة نساء قريش، وتسمى الطاهرة؛ وذلك لشدة عفافها، وكانت نقية ذات عقل واسع، وحسب، ومالٍ، لما سمعت رضي الله عنها بعظيم أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحسن أخلاقه، فقد عرفت أنه رجل لا تستهويه حاجة، وأنه لا يتطلع إلى مال، ولا إلى جمال، فحدَّثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منية، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يتزوج خديجة، فرَضِيَ صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه، فأقرُّوا له ذلك، ورضُوها زوجة له صلى الله عليه وسلم، فخرج معه عمه أبو طالب، وعمه حمزة، حتى دخلوا على عمرو بن أسد عم خديجة رضي الله عنها، فخطبوا إليه ابنة أخيه، وحضر العقد رؤساء مُضَرَ، فقام أبو طالب فخطب، فكانت خديجة رضي الله عنها أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها، حتى ماتت.
دروس وعبر وفوائد من السيرة النبوية (4)
أهم وأشهر الأحداث قبل البعثة
سبق أن ذكرنا أن أهم وأشهر الأحداث قبل النبوة: حادثة شق الصدر؛ وقعت له وهو طفل، وعند البعثة، وكذلك عند الإسراء والمعراج، ورعي الغنم، والتجارة مع الصدق والأمانة، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها؛ وهذه أربعة أمور.
[5] صيانة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مما كان عليه أهل الجاهلية من اللهو وسماع الغناء والمزامير:
شب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظه الله عز وجل، ويعصمه من أقذار الجاهلية ومعايبها، ويتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مظاهر عصمة الله عز وجل له في صغره، وقبل النبوة قائلا في حديث علي بن أبي طالب: ((ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به، إلا مرتين من الدهر، كلتيهما يعصمني الله منهما، قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهله يرعاها: أبصر إلى غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة، كما يسمر الفتيان، قال: نعم، فخرجت، فجئت أدنى دار من دور مكة، سمعت غناء، وضرب دفوف، ومزامير، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانة، لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش، فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا حر الشمس، فرجعت فقال: ما فعلت؟ فأخبرته، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك، ففعل، فخرجت، فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس، ثم رجعت إلى صاحبي فقال: فما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية، حتى أكرمني الله بنبوته))[1].
واستدل به ابن حبان على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه؛ يعني في أمور العقيدة والأخلاق الرذيلة[2].
وفي «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (4/ 25): "فبيقين ندري أن الله تعالى صان أنبياءه عن أن يكونوا لبغية، أو من أولاد بغي، أو من بغايا، بل بعثهم الله تعالى في حسب قومهم، فإذا لا شك في هذا، فبيقين ندري أن الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة، فدخل في ذلك السرقة والعدوان، والقسوة والزنا، واللياطة والبغي، وأذى الناس في حريمهم وأموالهم وأنفسهم، وكل ما يعاب به المرء، ويتشكى منه ويؤذى بذكره".
وفي «مختصر تاريخ دمشق» (2/ 86): "باب عصمة الله بالرسالة عما كان يرتكبه أهل الجهالة".
الاستماع للغناء وضرب الدفوف والمزامير، كان أمرا طبعيا لعرف أهل البلد، وكان شرب الخمر أمرا مألوفا غير مستنكر ولا مستهجن، وأكل الربا والميسر، والكبر والفخر، ولم يكن من المألوف عندهم فعل الفواحش، ولا اختلاط النساء بالرجال، ولا تبرج النساء والكشف عن العورات، ولا الاعتداء على النساء والأطفال.
وقد ذكر القرآن بعضا من أمور الجاهلية؛ كما في قوله تعالى: ﴿يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا * وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله﴾ [الأحزاب: 32، 33].
فقوله تعالى: ﴿فلا تخضعن بالقول﴾ [الأحزاب: 32]؛ أي: لا تلن بالكلام، ﴿فيطمع الذي في قلبه مرض﴾ [الأحزاب: 32]؛ أي: فجور، والمعنى: لا تقلن قولا يجد به منافق أو فاجر سبيلا إلى موافقتكن له، والمرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة؛ لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة.
﴿وقلن قولا معروفا﴾ [الأحزاب: 32]؛ أي: صحيحا عفيفا لا يطمع فاجرا.
وقوله: ﴿وقرن﴾ [الأحزاب: 33] قرئ بكسر القاف من الوقار، وبفتح القاف من القرار، ومعنى الآية: الأمر لهن بالتوقر والسكون في بيوتهن، وألا يخرجن إلا لحاجة.
وقوله تعالى: ﴿ولا تبرجن﴾ [الأحزاب: 33] التبرج: إظهار الزينة وما يستدعى به شهوة الرجل.
وفي صفة تبرج الجاهلية الأولى أقوال: قيل: إن المرأة كانت تخرج فتمشي بين الرجال، فهو التبرج، وقيل: إنها مشية فيها تكسر وتغنج، وقيل: إنها كانت تلقي الخمار عن رأسها ولا تشده، فيرى قرطها وقلائدها، وقيل: إنها كانت تلبس الثياب لا تواري جسدها.
وما زال الأمر كذلك عند بعض المسلمين مع مجيء الشريعة بالنهي عن ذلك، فهناك الكثير من المحرمات والكبائر يقع فيها بعض المسلمين، وأصبحت من باب العادة والإلف، ومن ذلك تبرج النساء، واختلاط النساء بالرجال، وغناء النساء للرجال والعكس، ومشاهدة ما يسمى بالأعمال الفنية بما فيها من الأمور السابقة، إضافة لإثارة الشهوات والمقاطع القبيحة التي تخدش الحياء، ولم يرد الترخيص في شيء من ذلك ألبتة.
وإنما رخص في شيء من الغناء وضرب الدف للنساء والجواري الصغار في يوم عرس أو يوم عيد، دون أن يصحبه شيء من المحرمات؛ كالاختلاط والعري والتبرج، ونظر الرجال للنساء والنساء للرجال؛ لما يترتب على ذلك من فساد القلب.
ومع ورود الرخصة للنساء والجواري في ضرب الدف في العرس، فإنه لم يرخص للرجال في ذلك؛ ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف))، فهذا للنساء، وكذلك أبيح للجواري الصغيرات الغناء بكلام مؤدب، ليس فيه فحش ولا تهييج للمشاعر، ولا يؤدي لفساد القلب.
وإذا نظرت لواقع المسلمين فيما يتعلق بهذا الصدد - وهو الغناء والمزامير والموسيقى والطرب - لرأيت العجب العجاب.
وما زال أهل العلم يستنكرون توسع المسلمين في هذا الباب، ويستنكرون على من يقول بجواز ذلك وإباحته، وليس هذا معناه أن الشريعة الإسلامية تحرم على المسلمين كل أنواع اللهو والمرح، ولكن الأمر فيه تفصيل، والغريب والعجيب حقا هو انشغال المسلمين وانخراطهم في اللهو واللعب والمرح، حتى في أوقات الشدائد والأزمات والفتن، بل وفي وقت الحرب مع الكافرين، وهذا من التغريب والتجهيل الذي يمارسه الغرب بحق أبناء الأمة الإسلامية.
ففي وقت الحرب والقتال، والجوع والفقر، والعطش والمرض الذي أصاب بعض إخواننا المسلمين، ومع ذلك هناك من هو مشتغل بكل المحرمات، وكل أشكال اللعب واللهو.
الانشغال باللهو والمباحات وتأثير ذلك في العقل والقلب، وما يؤول إليه الأمر من شغل القلب وتعلقه، وتأثير ذلك على انتفاعه بالقرآن والصلاة والذكر.
أولا: الغناء يصد عن القرآن، هذا لا شك؛ فالقرآن كلام الرحمن، والغناء كلام الشيطان، ولا يجتمعان في قلب إلا أخرج أحدهما صاحبه؛ فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى، ويأمر بالعفة، ومجانبة شهوات النفوس، وأسباب الغي، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله، ويحسنه، ويهيج النفوس إلى شهوات الغي فيثير كامنها، ويزعج قاطنها، ويحركها إلى كل قبيح، فهو والخمر قريبان.
ثانيا: الغناء رقية الزنا وبريده؛ قال الفضيل بن عياض: "الغناء رقية الزنا"؛ أي: إنه سبيله والداعي إليه والمرغب فيه.
ثالثا: الغناء ينبت النفاق في القلب؛ عن ابن مسعود والضحاك وعمر بن عبدالعزيز: "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع".
رابعا: سماع الغناء يورث قسوة في القلب، ويؤثر على التزام المرء بالطاعات، والواجب على من ابتلي بشيء من ذلك التوبة والرجوع إلى الله.
دروس من السيرة النبوية (6)
أهم وأشهر الأحداث قبل البعثة
(6) حرب الفجار:
ولخمس عشرة من عمره صلى الله عليه وسلم كانت حرب الفجار بين قريش ومن معهم من كنانة، وبين قيس عيلان، وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية؛ لمكانته فيهم سنا وشرفا، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس، وسميت بحرب الفجار؛ لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فيها، وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينبل على عمومته؛ أي: يجهز لهم النبل للرمي.
فهنا أمران نقف عندهما:
(1) هذه الحرب كانت بسبب قتل رجل من كنانة لرجل من قيس عيلان، فقامت الحرب بين القبيلتين، وكانت قريش حليفة لكنانة فدخلت في صفها؛ يعني أن هذه الحرب قامت بسبب قتل رجل واحد فقط؛ هذه نقطة، ونقطة أخرى أن قريشا دخلت في هذه الحرب لمحالفتها لكنانة؛ إذ ليس من المروءة ولا أخلاق العرب نقض التحالف وعدم الالتزام به، وإلا كان عارا ومسبة، فهذه الحرب ما هي إلا مثال على الحمية والعصبية التي كانت في الجاهلية، والحمية هي الأنفة والاستكبار المذكورة في قوله تعالى: ﴿ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ﴾ [الفتح: 26]، وهي العصبية لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، والأنفة من أن يعبدوا غيرها، وأنفتهم من الإقرار له بالرسالة، وهو الاقتداء بآبائهم، وألا يخالفوا لهم عادة ولا يلتزموا لغيرهم طاعة، والحمية التي جعلوها هي حمية أهل مكة في الصد، وحمية سهيل ومن شاهد عقد الصلح في أن منعوا أن يكتب: (بسم الله الرحمن الرحيم)، ولجوا حتى كتب: (باسمك اللهم)، وكذلك منعوا أن يثبت: (هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله)، ولجوا حتى قال صلى الله عليه وسلم لعلي: ((امح واكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله))، ووصفها تعالى بأنها حمية جاهلية؛ لأنها كانت بغير حجة وفي غير موضعها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاءهم محاربا، لعذرهم في حميتهم، وإنما جاء معظما للبيت لا يريد حربا، فكانت حميتهم جاهلية صرفا.
(2) وسميت بالفجار وهو الفجور؛ لاستحلالهم القتال في الأشهر الحرم وفي البلد الحرام؛ وفي صحيح البخاري عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة[1]: ائذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به: حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب))، فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة.